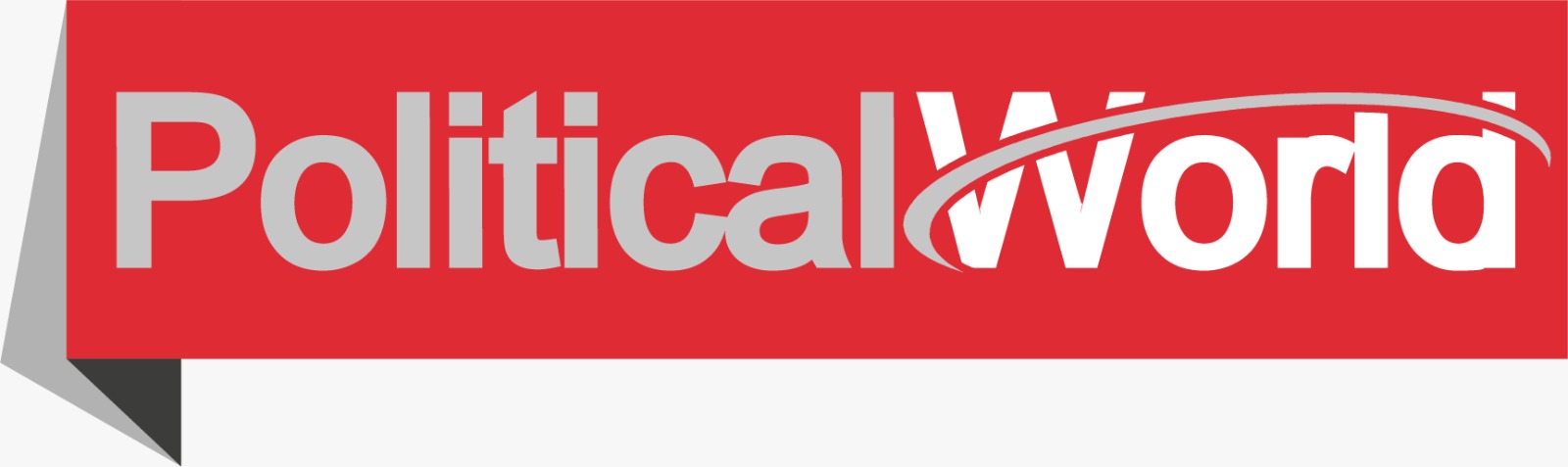تُعيد عملية ترحيل نشطاء إسبان معادين للوحدة الترابية للمغرب، فور وصولهم إلى مطار العيون، فتح النقاش حول حدود حرية العمل الحقوقي الأجنبي عندما يتقاطع مع مقتضيات السيادة الوطنية وحماية النظام العام، في سياق إقليمي ودولي شديد الحساسية تجاه قضية الصحراء المغربية.
ومن ثمّ، تبرز هذه التطورات باعتبارها اختبارًا دقيقًا لتوازن الدولة بين احترام التزاماتها الحقوقية الدولية وصون ثوابتها الدستورية، إذ تؤكد السلطات أن قرارات المنع والترحيل لا تستهدف العمل الحقوقي المشروع، بقدر ما تتصدى لأنشطة سياسية متخفية تحت غطاء مدني، تتجاوز الرصد إلى الترويج لأطروحات انفصالية تمس بالوحدة الترابية.
وفي هذا الإطار، يرى فاعلون حقوقيون أن جزءًا من هذه التحركات يندرج ضمن ما يشبه “التحرشات بالوكالة”، حيث تُستثمر شعارات حقوق الإنسان لتغذية حملات دعائية ضد المغرب، مع غضّ الطرف عن انتهاكات جسيمة بمخيمات تندوف، وهو ما يطرح تساؤلات أخلاقية ومهنية حول انتقائية الخطاب الحقوقي ومعايير الحياد والاستقلال.
وبالموازاة، يشدد خبراء في القانون الدولي على أن للدول، وفق المواثيق الأممية، سلطة سيادية كاملة في مراقبة دخول الأجانب وتقييد أنشطتهم متى تعارضت مع الأمن العام وسلامة الأراضي، مؤكدين أن منع نشطاء ثبتت نيتهم في دعم تنظيم انفصالي أو التحريض على اضطرابات مدنية يظل إجراءً مشروعًا ينسجم مع مبادئ السيادة وعدم التدخل.
وعليه، تتقاطع القراءات الرسمية والأكاديمية حول أن المغرب، وهو يدير هذا الملف، يسعى إلى تحصين قضيته الوطنية الأولى دون الانزلاق إلى تضييق ممنهج على الفعل الحقوقي الجاد، بل عبر فرز واضح بين الممارسة المهنية المستقلة وبين توظيف الحقوق كأداة ضغط سياسي وإعلامي.
وفي الختام، تبدو معادلة “الحقوق والسيادة” مرشحة لمزيد من الجدل كلما تجددت محاولات استغلال الساحة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية، غير أن المؤكد أن الدولة ماضية في تثبيت خط أحمر واضح: لا تسامح مع أي نشاط أجنبي يمس بثوابت الأمة ووحدتها الترابية.